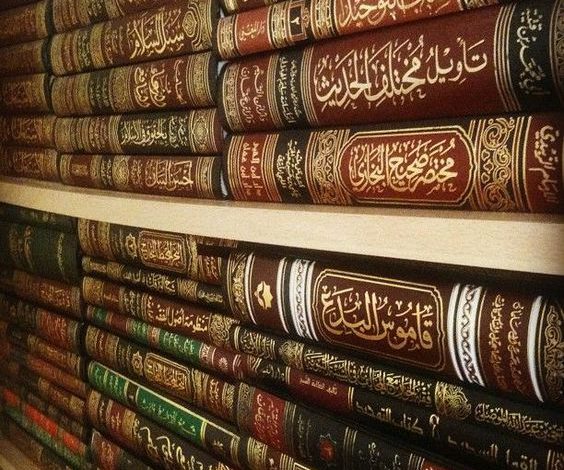
سبع مهارات فعالة لمستقبل العلوم الشرعية
د. مسعود صبري
مع تطور التعليم الشرعي والانتقال من (شيخ العمود) إلى التدريس النظامي في المعاهد الدينية والكليات الشرعية أضحى مما يكاد متفقًا عليه ضعف التعليم في المعاهد والجامعات الشرعية، مما يتطلب تفكيرًا جادا في إعادة النظر إلى المناهج التي تدرس، وكذلك الحال إلى طريقة التدريس، وكذلك إدارة العملية التعليمية في ظل التضخم والتطور في الأساليب التربوية الحديثة، التي سهلت كثيرا من المعارف والعلوم، وجعلت الابتكار والإبداع ساطعا فيها، وملحوظا عليها، خاصة في المجال التطبيقي، وعالم اللغات، وعلوم التكنولوجيا وغيرها.
إن علوم الشريعة مازالت هي أقل العلوم تطورا، سواء على مستوى تطوير المحتوى، أو تطوير الشكل، أو تطوير وسائل التعليم وأدواته، وإذا أردنا أن نسعى لتطوير تدريس علوم الشريعة والعربية من باب أنها تبع لها، فيجب أن تتضافر الجهود لوضع منهج تجديدي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، يحافظ على القديم الصالح، والجديد النافع.
إن نجاح العملية التعلمية في علوم الشريعة يجب أن يتناول خمسة جوانب مهمة، هي:
أولا- العناية بالمؤسسات التعليمية.
ثانيا- تأهيل جمهور الطلاب، وهل هناك معايير معينة لقبول الطلاب في الدراسات الإسلامية أم يتاح لكل الطلاب؟
ثالثا- إعادة النظر إلى مضمون المقررات التعليمية، بما يتناسب مع روح العلم من ناحية وروح العصر من ناحية أخرى.
رابعا- طريقة تدريس علوم الشريعة لإيصال المحتوى بطريقة جيدة، وتأهيل المعلمين والأساتذة القائمين على تعليم علوم الشريعة.
خامسا- وضع مقاييس لمدى كفاءة العملية التعليمية في علوم الشريعة.
كما أن مستقبل علوم الشريعة يحتاج إلى منهج متكامل يجمع بين: فقه الشرع من ناحية، وفقه الواقع من ناحية، وفقه تنزيل الشرع الثابت على الواقع المتغير، حتى يكون المنهج مقتربا من المنهج النبوي ومنهج الراشدين، كما أنهم يسهم في الفقه الحضاري للأمة كلها.
وتتطلب إعادة النظر في تطوير تدريس علوم الشريعة ما يلي:
- أولا- تقريب التراث:
إن تراث علماء المسلمين فيما كتبوه وصنفوه في شتى العلوم هو أحد أهم مصادر المعرفة عن الإسلام وشريعته، ولا يمكن لباحث أن يتجاهل هذا التراث بتلك الدعاوى التي تقول: إنه يجب علينا ترك التراث بالكلية، والنظر إلى نصوص الوحي من الكتاب والسنة لنستخرج منها منهج النظر والبحوث بما يتماشى مع عصرنا، فهذا نوع من التطرف في الفكر، وغمط للحق، وفي ذات الوقت، هناك نظرة متطرفة – أيضا- ترى تقديس التراث بكليته، وأنه يجب تقديم التراث كما هو دون تغيير أو تبديل؛ مستندين إلى أن هذا التراث هو الذي كان سببا في تطور المسلمين وبناء حضارتهم.
والحق أننا بحاجة إلى النظر إلى التراث بنظرة معتدلة بين التقديس والتبخيس، فقد تبقى لنا من التراث ما يقارب ثلاثة ملايين من عناوين الكتب، ففي المكتبة الوطنية بفرنسا وحدها هناك ما يقارب من ستة ملايين من المخطوطات العربية، وفي مصر هناك ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف مخطوط عربي، وفي مكتبة السليمانية بتركيا هناك ما بين سبعين ألف إلى ثمانين ألف مخطوط عربي، وهناك مخطوطات أخرى في عدد من الدول، كالمكتبة الظاهرية في دمشق، التي نقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق، وغيرها من البلاد. وقد قامت دور النشر بتحقيق عدد لا بأس به.
إن هذه الثروة الرائعة يجب النظر إليها بعين الرعاية والتقدير بما يطور العملية التعليمية من خلال عملية (تقريب) للتراث، فيحفظ محتواه ولكنه يكتب بطريقة معاصرة ولغة مفهومة بعيدة عن اللغة القديمة باعتبار أن كل عصر له قاموسه، وإن التصنيف العلمي في حد ذاته بلغته القديمة ليس مقدسا، وإنما هو وسيلة للفهم والإفهام، وقد أبان الله تعالى عن أن المقصود من الإرسال والتعليم هو الإفهام، كما قال {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } [إبراهيم: 4]
لكن المصنفات القديمة امتازت بأمرين:
الأول: المنهجية: فغالب ما كتب في القديم له منهجية واضحة تساهم في البناء المعرفي للعقل المسلم.
الثاني: غلبة الإخلاص والتجرد، مما جعل لهذه الكتب قبولا عند العامة والخاصة، لأنهم لم يكونوا يكتبون للتكسب كما هو غالب الحال الآن، وإنما يكتبون خدمة للدين والعلم.
وقد نحتاج في عملية التقريب أن نحذف بعض الأمثلة القديمة التي تناسب عصرهم دون عصرنا، وأن نأتي بأمثلة معاصرة، مع إبقاء كل ما هو صالح لزماننا، وقد نضيف عليها بعض المسائل المستجدة التي استحدثت في عصرنا دون عصر الأقدمين.
- ثانيا- سلم التعلم:
ومن مزايا منهج القدامى في التعلم هو ما قالوه من أن الإنسان لا يتحصل العلم إلا إذا درسه ثلاث مرات، وقد عبروا عنه بدراسة المختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، وتقوم هذه الطريقة على شرح متن معين بطريقة مختصرة، فإذا انتقل الدارس إلى الطريقة المتوسطة فإنه يجد فيها ما درس في الطريقة المختصرة وزيادات، ثم ينتقل إلى مرحلة المطولات، فيدرس فيها ما درسه في المختصرات والمتوسطات مع زيادات، فيثبت العلم في ذهن الطالب.
وهذا بخلاف ما يدرس في الكليات الشرعية الآن، فهي مقسمة إلى مواد دراسية تدرس كل مادة مرة واحدة يختبر فيها ولا يرجع إليها، مما يعني أنه يتحصل ثقافة لا علما.
كما أن طريقة التدريس في الجامعات ليست متدرجة، فمستوى المادة واحد منذ البداية، وطريقة السلف الصالح أن يدرس الطالب القواعد والمسائل العامة أولا، ثم بعد ذلك يتوسع بذكر الأدلة والخلاف في المذهب أو بين المذاهب ونحو ذلك.
- ثالثا- الشكل والقالب:
شهد العالم طفرة في قوالب الطباعة وتقديم الكتاب بأشكال متنوعة، أدت الصورة فيه دورا كبيرا، فبجوار الطريقة التقليدية لصف وطباعة الكتاب، خرجت لنا كتب مزينة بالصور وبرسم الأشكال الفنية التي تعطي حيوية للكتاب، وتساهم في الإفهام والتقريب بما بات يعرف بـ ” الخريطة الذهنية” وهي طريقة تجعل الطالب مقبلا على العلم، كما أنها تساهم في إيصال المعلومة بشكل أفضل من الطريقة التقليدية.
وقد تبنى هذه الفكرة كثير من المتخصصين في العلوم التجريبية والعلوم الإدارية، لكن مازالت العلوم الشرعية يغلب عليها الطريقة التقليدية، مما يتطلب تفكيرا جادا في طباعتها بأشكال متنوعة معاصرة تسهم في جذب الطلاب للكتب الشرعية.
- رابعا- ضرب الأمثال:
يعد ذكر الأمثلة من أهم وسائل التعلم، ولأهمية الأمثال فقد ضربها الله تعالى في كتابه تبيانا للناس وتعليما، كما جاءت السنة حافلة بضرب الأمثال، لكن كثيرا من كتب علوم الشريعة قلت فيها الأمثال، بل تكاد تكون الأمثلة متكررة من كتاب لآخر، دون مراعاة للعصر الذي كتب فيه، أو البيئة التي يدرس فيها.
ومن هنا كان من الواجب العناية بتكثير ضرب الأمثال؛ إفهاما وتفهيما، وإعقالا وتعقيلا، ووصولا وإيصالا، حتى تثبت القواعد في ذهب الطالب، وحتى يرسخ ما تعلمه؛ لأن المثل أبقى في الذهن وأرسخ في العقل، وأدعى إلى الفهم.
- خامسا- التدريب والمهارات:
غالب العلوم النظرية قائمة على التثقيف، لكنها لا تملك الطلاب أدوات العلم، ولا تحقق المخرجات التي يجب أن يستفيد بها المجتمع، فغالب الكليات الشرعية التي تخرج أئمة وخطباء لا نجدهم يتدربون على الإمامة والخطابة، ولا يعرفون كيفيتها، وإنما يمكثون سنوات حتى يأخذوا الدربة من كثرة العمل، وكذلك خريجو كلية اللغة العربية، فهم لا يتدربون على التدريس ولا على التصحيح اللغوي ولا غيرها من الوظائف التي يقومون بها بعد التخرج، وهكذا بقية الكليات الشرعية واللغوية، وكان يمكن توفير سنوات بعد التخرج التي يقضيها الخريجون في التدرب، وأن يكون ذلك خلال سنوات التعلم، وأن يقوم البناء التعليمي على شقي: المعرفة والتدريب، وأن يقل الحشو النظري في مقابل تحويل العلوم إلى مهارات.
اقتراح لأقسام علوم الشريعة والعربية:
ويمكن إعادة تقسيم الكليات إلى أقسام حسب الوظائف والمخرجات للمجتمع، ففي كليات اللغة العربية تكون هناك أقسام: التصحيح والتحرير اللغوي، وقسم: التدريس، وقسم: الإعداد العلمي في علوم العربية وغير ذلك من الأقسام.
وفي الكليات الشرعية تكون هناك أقسام، مثل: قسم الإمامة والخطابة، وقسم: البحث الشرعي، وقسم: التدقيق الشرعي الخاص بالمؤسسات المالية، وقسم: الصحافة الشرعية، وقسم: الإعلام الديني، وقسم: التدريس الشرعي، وقسم: المحاماة، وقسم: التحقيق الجنائي، وغير ذلك من الوظائف التي يقوم بها خريجو الكليات الشرعية.
إن نجاح المؤسسات التعليمية الشرعية قائم على معرفة مقاصد العلوم، لأنه كما أشار الإمام الغزالي في كتابه: ( المستصفى) أن الدارس لا يتحصل العلم إلا بثلاثة أمور، هي: معرفة التصور العام للعلم، وإدراك مقاصد العلم، وتحصيل مسائل العلم.
وهذا النظر غاية في الأهمية، فحين يدرس الطلاب مصطلح الحديث دون امتلاك مهارة تمييز الحديث الصحيح عن غيره، فلم يتملكوا مقصد العلم، وإن درسوا قواعد العربية دون امتلاك مهارة النطق الصحيح والكتابة الصحيحة وتصويب الخطأ، فلم يمتلكوا مهارة العلم، وهكذا.
- سادسا- الجمع بين الطريقة التقليدية والطريقة الأكاديمية:
لقد أثبتت الطريقة التقليدية في تعليم علوم الشريعة ، أو ما كان يعرف بـ” شيخ العمود” كفاءتها في التحصيل والاستظهار، وهذا ما لا نجده في الطريقة الأكاديمية، وأثبتت الطريقة الأكاديمية قدرتها على تحرير العقل من التقليد، وعدم الوقوف عند درس الشيخ فحسب، بل ملكته مهارات البحث والتنقيب العلمي، مما يساهم في تكوين ملكة الاجتهاد الجزئي، مما يعني أننا بحاجة إلى طريقة تجمع بين الطريقتين، أو أن يكون بجوار الطريقة الأكاديمية منهج مصاحب على الطريقة التقليدية، حتى يجمع الطالب بين ملكة الاستظهار ومعرفة العلوم، وبين ملكة البحث والاجتهاد.
وهذه الطريقة تحتاج إلى مزيد عناية في صياغة المناهج، وطرق التدريس، وتدريب الطلاب عليها، حتى نصوغ عقلا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مستوعبا القديم النافع، مستعملا للجديد الصالح.
- سابعا- التطبيق العملي:
تعد هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة من التدريب، فالتدريب يعني امتلاك المهارات، ثم تأتي مرحلة التطبيق لتعمق امتلاك تلك المهارات، وهي هنا ليست مرحلة تعلم بقدر ما هي مرحلة ممارسة، لأن الطالب – بلا شك- يتعلم بكثرة التطبيق، فقد يتعلم الطالب مهارات التخريج، أو مهارات البحث، لكنه كلما خرّج أو كتب بحوثا كلما علت قدرته وكفاءته الإنتاجية، وكذلك الخطيب والإمام كلما مارس المهنة كلما اكتسب خبرات أكثر، فيتعلم من خلال الواقع المهني كما تعلم من خلال التنظير والتقعيد مع تطبيقاته خلال المرحلة الدراسية.
إن الطفرة التعليمية التي يشهدها عصرنا وستشهدها عصور بعدنا قد أتت ثمارها في كثير من العلوم التجريبية والإنسانية من غير علوم الشريعة، مما يعني أنه آن الآن للسعي نحو تجديد منهجي لتدريس علوم الشريعة، تجديدا يشمل المحتوى العلمي، كما يشمل تطوير أدوات التدريس وطرقه والعناية بالمعلمين القائمين على عملية التدريس، ناظرين إلى المهن والوظائف التي تعد ترجمة حقيقية لخدمة المجتمع من تلك العلوم حتى ثبت لها قدما راسخا؛ لتنال مزيدا عناية ورعاية واهتمام.
للمزيد عن سبع مهارات فعالة لمستقبل العلوم الشرعية اقرأ أيضا




